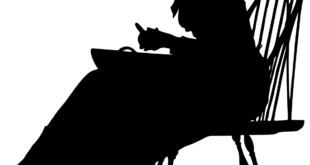هل يتوقف العالم من أجل حُزن أحدنا؟
تلك اللحظات المُروِّعة التي تدرك فيها بأنّ العالم لا يأبه لحُزنك، ولا يهتم لكونك مُحطَّمًا يائسًا، وربما لا ينتبه -مُطلقًا- لوقوفك على حافة الهاوية استعدادًا للقفز. تراه يستمر في المسير كما يفعلُ عادةً، هو -فقط- يستمر، بصرف النظر عن كلِّ الأشياء يستمر، حينها تنتابُك الرغبة في الصراخ بكل ما أوتيت من حُزن: “ليتوقف كلُّ شيء. أو لينفجر!”.
كنتُ أتساءل دومًا ألا نستحق أن يتوقف العالم من أجل حُزن أحدنا؟ من أجل شعوره التام باليأس؟ من أجل قلبه المُمَزق؟ من أجل دموعه المُنهمِرة؟ ألا نستحق أن يتوقف العالم ولو للحظةٍ واحدة مؤازرةً لنا على ما نشعر؟ لطالما كانت الحياة غير عادلة، إلا أنها أنانيةٌ كذلك في واقع الأمر.
الحياة القبيحة
أكادُ أتخيلها فتاة قبيحة مُدلّلة تملك السلطة والمال، تخطو فوق جراح الجميع دون أن تُعيرهم أيّ اهتمام، ودون أن تلتفت إلى صراخهم وتأوّهاتهم. ومن خلفها يسعى الآخرون طمعًا فيما تملُك؛ فيخطون بدورهم على جراح الجميع، إلا أنّهم مع الوقت يُلعَنون، فيفقدون آدميتهم، ويفقدون ما كانوا يسعون للحصول عليه.
والآن، ماذا قد تعني دقيقة الحِداد التي يقفها الناس حين يفقدون أحدهم؟ ماذا تعني لمَن رحل؟ هل حقًا تعني له الشيء الكثير؟ هل يأبه لها أصلاً؟ أم أنه إذا خُيّر بينها وبين دقيقة في حياته -حين شعر بالحُزن يجتاح قلبه واليأس يُسيطر عليه- كان ليختارها في حياته؟ ماذا تعني الأزهار المنثورة على القبور؟ ماذا تعني قصائد الرثاء؟ ماذا تعني إقامة المآتم والجنازات؟ ماذا يعني كل هذا لمن قد رحل بالفعل؟.
الرسول يلاطف الفتى الحزين
يُذكّرني هذا بحادثة الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع ذلك الطفل الصغير الذي لم يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وكان له عصفورًا يلعبُ معه يُدعى النُغير. وهي كما يرويها أنس بن مالك في إحدى الروايات “أنّ النبي كان يدخل على أم سُلَيم ولها ابنٌ من أبي طلحة يُكنَّى أبا عُمير، وكان يُمازحه، فدخل عليه فرآهُ حزينًا، فقال: مالي أرى أبا عُمير حزينًا؟ فقالوا: مات نغره الذي كان يلعب به، قال: فجعل يقول: يا أبا عُمير ما فعل النُغير؟”.
لقد توقف الرسول لحظةً من أجل حُزن ذلك الفتى الصغير، وأعطى له ما يستحق من الاهتمام والمُلاطفة؛ رفقًا بقلبه الرقيق الذي أصابه الحُزن مُبكرًا، فعل ذلك دون أيّة تنظيرات -عديمة الفائدة- عن كون الأمر لا يستحق؛ فالحُزن شعورٌ إنسانيٌ خالص، لا يملُك زمامه أحد، ولا يحتكره أمرٌ بعينه. فإن كان هناكَ مَن يشعر بالحُزن، إذًا فالأمرُ يستحق.
يقول دوستويفسكي: “قالت لي امرأةٌ في يومٍ من الأيام: ليس من حقّي أن أحكُم على الآخرين؛ لأنني لا أُجيد الألم، ومن أجل أن ينصب المرء نفسه حاكمًا وقاضيًا يجب عليه أن يكتسب حق الحُكم بما يُقاسي من الألم”. هذا ما كنتُ أعنيه بالضبط، ليس من حقك أن تحكم على الآخرين، أن تُقرّر لهم متى يجب أن يحزنوا، ومتى يجب أن يكفّوا عن البكاء، وما إن كان الأمر يستحق كلّ ذلك القدر من الألم أم لا. أنت -أبدًا- لم تكُن في موضعٍ يسمح لك بأن تنصب نفسك قاضيًا على الآخرين، أنت -أبدًا- لم تكُن في مكانهم حتى لو هُيّأ لك ذلك.
ماذا يحتاج الحزين من الآخرين؟
ربما لا يحتاج الآخرون منك سوى التوقُّف لحظةً من أجلهم، سوى أن يشعروا بأنّ هناك من يهتم لأمرهم بالفعل، أنّهم ليسوا وحيدين إلى تلك الدرجة، وأنّ أحدهم قد توقف عن السير؛ مؤازرةً لهم في ما تختلج به صدورهم، وما تنطوي عليه أفئدتهم. يُروى أنّه في حادثة الإفك قد دخلت إمرأةٌ من الأنصار على السيدة عائشة -رضي الله عنها- وبكت معها كثيرًا دون أن تنطق بكلمة، فقالت عائشة: “لا أنساها لها”.
نعم والله لم تكن لتنساها لها، ولم نكُن لننساها لهم، لأولئك الذين لم يتركونا وحيدين، لأولئك الذين قاسمونا الحزن والألم، ولأولئك الذين عجزوا عن مواساتنا بالكلمات، فبكوا معنا، وربّتوا على أكتافنا؛ فكأنما قد أزاحوا بفعلهم هذا نصف ما كُنّا نحملُ من ثِقَل. ليس من العدل أن يشعر أحدهم بالحُزن والألم وحيدًا، ليس من العدل ألا يجد من يُشاطره تلك المشاعر الثقيلة المُهلِكة.
كنتُ أرى دائمًا أنّه لا يوجد في هذه الحياة مَن يستحق الوحدة، فماذا لو كان الأمر لا يتوقف على كونه وحيدًا فقط، بل وكونه -أيضًا- يشعر بالحُزن والألم؟ كونه يقف على حافة اليأس وحيدًا؟ وكونه ينظر للجميع وهم يستمرون في حياتهم المعتادة متجاهلين -تمامًا- ما يضطرم في صدره؟ ربما لا يوجد ما هو أقسى على النفس من ذلك الشعور، وربما لا يدفع اليأس أحدهم لإنهاء حياته قدر ما يدفعه كونه يشعر بالوحدة في يأسه ذاك.
حكاية السيد زومّر
يروي الكاتب الألماني باتريك زوسكيند في روايته “حكاية السيد زومّر” قصة رجلٍ مُصاب بمرض الكلوستروفوبيا، أي رُهاب الأماكن المغلقة؛ مما يضطره للسير وحيدًا طوال اليوم تقريبًا، ذهابًا وإيابًا دون هدفٍ أو وِجهَة، فقط ليستطيع البقاء على قيد الحياة مع ذلك المرض اللعين. كان السيد زومّر يعاني إلى أقصى درجة إلا أنه مع ذلك كان وحيدًا للغاية، لم يكُن يشعر به ولا بمعاناته أيُّ أحد، فقط يراه الجميع، يعلمون بشأن مرضه، ثم يسيرون كلُّ في طريقه وحياته.
في النهاية انتصرت الوحدة على السيد زومّر -ذلك الذي عجز المرض عن هزيمته- واستحوذت هي على المشهد بالكامل؛ فقد ضاعفت معاناته حد الجنون، وضاعفت يأسه حد الانهيار، ثم دفعته لإنهاء حياته؛ هربًا منها، وإنقاذًا لما تبقّى له من عقله. حينها تردّدت في رأسي عبارة الدكتور أحمد خالد توفيق: “أنا حزين. وأنتم أوغاد” وتبادر إلى ذهني أنّ السيد زومّر قد استعان بها ليرسم مشهد موته النهائيّ كما تخيّلته؛ حيثُ يُلقي نظرةً أخيرة على الجميع، يُردّد في نفسه: “أنا حزين. وأنتم أوغاد” ثم يُقدِم على الانتحار.
وهنا، يُنهي الأبنودي حديثي ببعض سطور الشعر فيقول:
“ياللّي خلقت الأمة من غير قلب،
من غير حُضن،
وخلقتها مابتحترمش الحُزن..
مأساتي إنّي حزين”
 موقع مقال موقع تواصل اجتماعي يتخذ من المقال وسيلة تعبير وتفاعل، وينتج فيديو عن كل مقال
موقع مقال موقع تواصل اجتماعي يتخذ من المقال وسيلة تعبير وتفاعل، وينتج فيديو عن كل مقال